«الصورة مش واضحة بس مش هتفرق»: هل نحتاج إلى فهم الفن؟
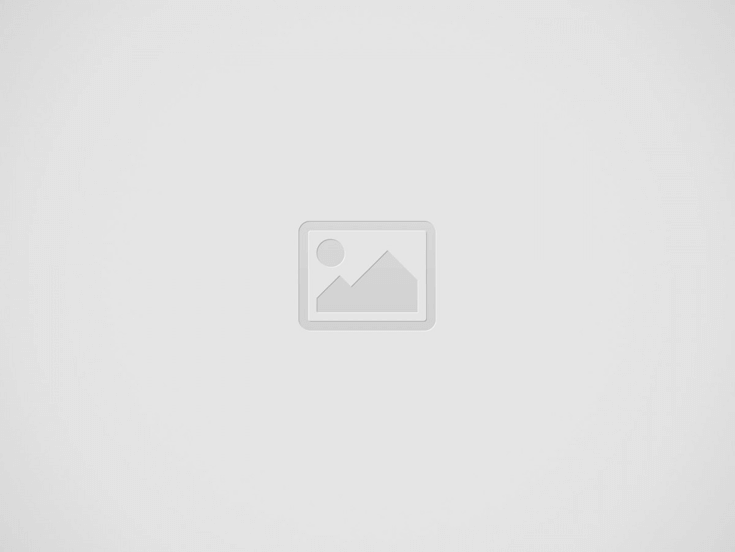

لقطة من النسخة المُصورة لأغنية «غابة» لمغني الراب المصري مروان بابلو
كنتُ في عرض فيلم قصير ضمن إحدى الفعاليات السينمائية في القاهرة يتلوه نقاش مع الصُنَّاع حين سألت واحدة من الجمهور عن علاقة الرقص بموضوع الفيلم (الغضب). كان الفيلم مزيجًا من الكوميديا سهلة التفسير والأداء التمثيلي صعب التفكيك، مَشاهد تُحرِّكها الأحداث ومَشاهد تتحرك فيها الأجساد في رقصات معاصرة تطول نسبيًّا، كل هذا بعنوان: «مشط بدون أسنان»… ترددت فاطمة الزهراء، الكاتبة المشارِكة في العمل ومصممة رقصاته، في بداية إجابتها، وبدا واضحًا أنها تبذل جهدًا في تكوين الجُمَل، ثم راحت تفسِّر أنها لا ترى أن عليها شرح المعاني المُتضمَّنة في أي عمل فني أو إملاء طريقة مُعيَّنة في فهم الفن.
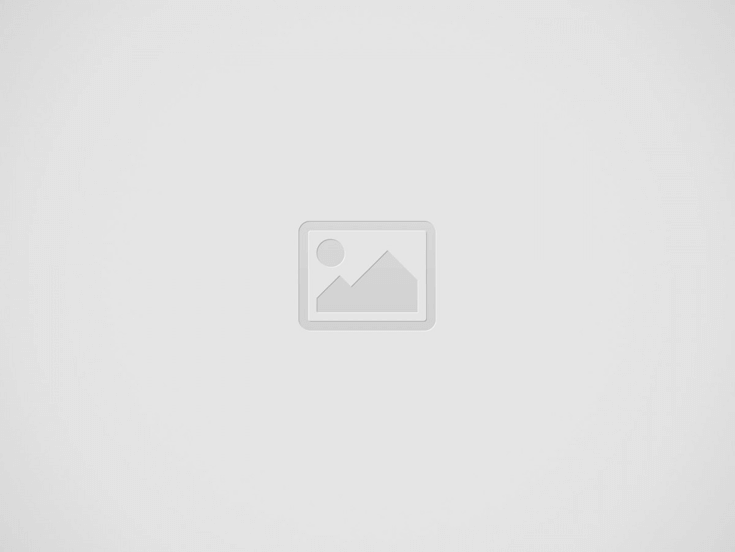

كنت أدرك تمامًا ما دار برأسها في تلك اللحظة، فقد عشت مثلها بعد عرض فيلمي الأخير في مهرجانات سابقة. أخرجتُ فيلمًا تسجيليًا دون حوار ولا شخصيات ولا تعليق صوتي ولا حركة كاميرا. ما كنت لأتوقع سوى أسئلة على هذه الشاكلة. لذا، في كل مرة يُعرَض الفيلم، أستعِدُّ بتنويعاتٍ على الإجابة نفسها: لا أشعر أنني يجب أن أشرح عملًا فنيًّا.
مع ذلك، لا أدَّعي أني فهمت تمامًا علاقة الرقصات في الفيلم المذكور بموضوع الغضب، ولا أسوق هذا العمل مثالًا هنا لأنه أعجبني. في الحقيقة، الكثير من الأفلام «التجريبية» في ذلك المهرجان لم يعجبني. ليس لأني لم أفهمها، فما زلت لا أجد ضرورة لفهم كل الأعمال الفنية، لكني أرى أن عليَّ أن أشرح لماذا أومن بذلك. إنما دعونا نتساءل أولًا..
لماذا نشعر بالرغبة في فهم الفن؟
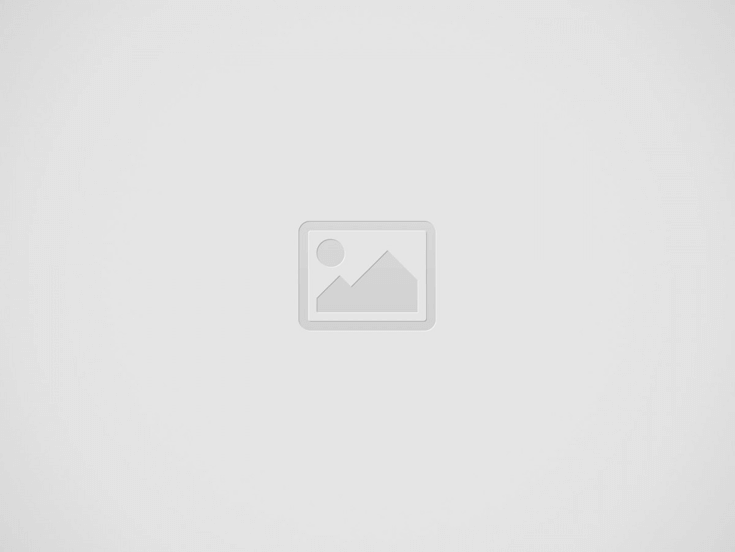

في عالم يسهُل فيه الوصول إلى أي معلومة بسرعة وفي أكثر من مصدر وبمستويات متعددة من التعقيد حسب رغبتنا، ليس غريبًا أن يتربى لدينا هَوَسٌ بالفهم المُطلَق، وفهم الفن بالضرورة. وحين نقضي سنوات دراستنا الطويلة في الإجابة عن أسئلة «علل» و«اكتب ما تعرفه عن»، لا عَجَب أن نخرج من المدارس إلى الحياة بسعيٍ محموم وراء تمام المعنى.
لكن هل هذه فعلًا وظيفة الفن؟ هل يجب أن نتوقع من المُبدعين أن يقدموا لنا أعمالًا مفهومة ذات معانٍ مباشرة يمكن تفسيرها في جمل أقل مما احتاجت إليه صانعة فيلم «مشط بدون أسنان»؟
سأستعير الإجابة من إدوار الخراط إذ يقول في كتابه «مجالدة المستحيل»: «لا أستطيع، ولا ينبغي، أن أُلقي لقارئي بنِتاجٍ مُنتهٍ.. نِتاجٍ مُستدير، مُغلَق على ذاته، قد تَمَّ تمامه وانتهى بالكامل. إنما أنا أُلقي إليه بدعوة للسياحة معي.. بدعوة للدخول إلى ساحة الخَلْق والمشاركة».
لحظة، لعلك تتساءل مَن إدوار الخرَّاط أصلًا؟ أنا أيضًا تعجبت من جهلي به حتى وقت قريب، حين أعادت دار نشر «المحروسة» طبع أعماله. هذا الكاتب والروائي المصري الذي كتب الشعر والنقد وترجَم أدبًا وتُرجِم أدبه هو إلى سبع لغات. لماذا لم يسمع باسمه الكثيرون؟ ربما يكون أحد الأسباب أنه أيضًا احترف الإبداع «غير المفهوم»، ذلك الذي لا يمكن النفاذ إلى معناه من القراءة الأولى، ولا يمكن ادِّعاء الإلمام بمعنى موحَّد له من الأساس.
في زمن «الرواية الواقعية» الذي تربَّع على عرشه نجيب محفوظ، أديب نوبل الذي تحوَّلت معظم رواياته إلى أعمال سينمائية، أصدر إدوار الخراط معظم أعماله لتُغرِّد شبه وحيدةً بأسلوب «تجريبي»، أو بما يعرف بـ«الكتابة عبر النوعية». كان للخراط تعريفه الخاص للواقع، إذ تتجاوز الواقعية عنده الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتشمل أيضًا الأساطير والأحلام والخيالات والهلاوس وكل ما يخص دواخل النفس البشرية، لا ما يدور حولها فقط.
هل ما لا نفهمه ليس فنًا؟
في مُستهل مراجعتها لعمل بعنوان «عمَّ نتحدث حين نتحدث عن الصداقة» صدر حديثًا وعلى غلافه -كعبه تحديدًا- كلمة «رواية»، كتبت واحدة من القراء: «بالتأكيد ليست رواية، فلا توجد حبكة أو قصة من الأساس»… هكذا، في سطرٍ واحد، وضعت القارئة تعريفًا جامعًا مانعًا للرواية، وحكمت بـ«عدم روائية» العمل نظرًا لخروجه -من وجهة نظرها- على ذلك التعريف.
لك أن تتخيل بالطبع أن أعمال إدوار الخراط لا تسلَم من التعليق نفسه. عن «حريق الأخيلة» مثلًا، كتب أحد القراء: «لا أعرفُ لِمَ سمَّاها رواية! هي ليست كذلك فعلاً، إنما ببساطة مجرد شذراتُ خواطرٍ من هنا وهناك».
يُذكِّرني هذا بالهجوم الحاد على مغني «الراب» و«المهرجانات» في بداية ظهورهم وحتى اليوم، إذ يرى الكثيرون أنهم يُغنون كلامًا غير مفهوم ويلحِّنونه بموسيقى مزعجة لا طعم لها، وبالتالي فكل ما يقدمونه لا يمكن اعتباره فنًّا، أو في أفضل الأحوال، لا يمكن تصنيفه «أغنيةً». لنأخذ مثالًا «الرابر» المصري مروان بابلو… ذات يوم كنت في عشاء يجمع دوائر مختلفة من أصدقاء مضيفته، وبالتالي آراءً متنوعة عن الحياة عمومًا. ولسبب ما، بدأ الحديث عن «تراك» بعنوان «الجمِّيزة» كان قد صدر حديثًا آنذاك، وسرعان ما تحولت الجلسة إلى قصيدة هجاء فيما يقدمه بابلو -وفيه شخصيًا- دون أدنى شك في كون ذلك ليس فنًا بالطبع.
والسؤال هنا: هل كان هذا نتيجة عدم فهم الكلمات؟ هل يشكِّل فرقًا مثلًا أن يعرف المتلقي أن «الجميزة» هي منطقة شعبية في الإسكندرية تتعلق بها بقية كلمات الأغنية التي يمكن تفسير معظمها إن أردنا؟ أم هل يرجع الهجوم لصعوبة «تصنيف» ذلك العمل «غريب الطابع» الذي لا يناسب أيًّا من القوالب المعروفة مسبقًا؟ أهذا ما يحدث حين لا «نفهم» عملًا فنيًا؟ أيجعله عُسر الفهم أقل فنيَّة؟ أم هل ينفي كونه فنًا من الأساس؟
في الطريق إلى فهم الفن: السؤال أهم من الإجابة
في تعليق مشابه لرأي القارئ المذكور سابقًا عن «حريق الأخيلة»، كتب قارئ آخر: «فور أن أنهيت الرواية تساءلت: هل هذه رواية؟».
على الأقل تخلَّى هذا القارئ عن أحكامه المسبقة والتعريفات الجامدة ووضع الأمر محل تساؤل لا يقين. لذا، مرة أخرى سأستعين بإجابة الخراط نفسه. يقول في كتابه «مجالدة المستحيل»: «قمت منذ سنوات بتجربة جديدة تنتمي إلى ما يسمى بالكتابة غير النوعية، ومن خلالها يتوحَّد الشعر والسرد والقَص والتصوف وينصهر في مقاطع قصيرة نسبيًا بالنظر إلى تجاربي السابقة، بحيث يمكن قراءة المقاطع مستقلةً ولكنها بالضرورة تثري بعضها بعضًا -فيما أرجو- وتشكِّل في النهاية نصًا واحدًا أطلقتُ عليه رواية على سبيل التحدي للقارئ والاستفزاز لملكته النقدية ومشاركته في العملية الإبداعية. كما لو كنت أقول مرة أخرى إن كلمة رواية تعني جنسًا أدبيًا مفتوحًا متعدد السمات».
هل يمكن دائمًا فهم الفن؟
لا أدَّعي امتلاكي لصبرٍ غير حدود على كل أشكال العمل الفني، أو إعجاب غير مشروط بمنتجات جميع المبدعين. في الحقيقة، لدي تحفظاتي على أدب وفِكر إدوار الخراط نفسه، وبخاصة صورة المرأة في أعماله. وكذلك أجد استخدام المرأة في أعمال معظم مغني «الراب» ذكوريًا فظًّا، بالإضافة لكون كثير من «تراكات» الراب عنيفة ومُبتذلة وفقًا لذوقي الشخصي، نفس الذوق الشخصي الذي يحب الاستماع إلى الراب كثيرًا وإن لم تعجبه الكلمات أحيانًا. تلك المناطق التي أختلف فيها مع بعض المبدعين لا تجعلني أسمح لنفسي بتجريدهم من صفة الإبداع بالكامل.
منذ فترة، قرأت مجموعةً شعريةً بعنوان «بلا مقابل، أسقط أسفل حذائي»، لم يعجبني منها سوى قصيدة واحدة. ولم أخرُج فيما عدا تلك القصيدة بأي «معنى»، لدرجة أني تذكرت حكاية كان قد شاركها شاعر معروف نسبيًا مع أحد أصدقائي، إذ شرح له كيف يبني نصوصه بالكامل عن طريق جمع أكثر التعبيرات والمفردات «غرائبية» وأبعدها صلة ببعضها بعضًا، لكي يُنتج قصيدة نثر متفرِّدة بلغة غير مسبوقة، غير أنه يستحيل تقريبًا أن تخرج منها بـ«معنى».
حين أنهيت ذلك الديوان، وجدت مُتنفسًّا لإحباطي في مراجعة تنتقد تلك الطريقة في كتابة الشعر. كان نقدًا حادًا لكنه منطقيٌ في الوقت نفسه، من النوع الذي يشفي غليلك دون أن تشعر بجورٍ على الكاتب. ضغطت زر الإعجاب لتفريغ غضبي، ونسيت الديوان، وكدت أنسى المراجعة نفسها، إلى أن شرعت في كتابة هذا المقال. حينها عدتُ إلى صفحة المراجعات لأتذكر ذلك النقد، لكن ما لفتني هذه المرة كان مراجعة قارئة أخرى للعمل نفسه. على النقيض تمامًا، قد أعجبها الديوان، بينما لا يزال نقدها واعيًا بما جاء فيه. تقول: «الكثير من الكوابيس والغيوم والعظام والهرطقات. أشعار تشبه أحلامي في الليل، وأفكاري تحت الحمى. غريب ولكن أحببته».
بهذه البساطة استطاعت أن تشرح ضمنيًّا كيف يمكننا أن نعي كون ما نتلقاه «غريبًا»، لا يخضع لما نتوقع، وقد لا يناسب أي تصنيف، ولكننا في الوقت نفسه نقبله، بل نستعذبه، ونخلق معه نوعنا الخاص من الصِلة والتأويلات.
«لو ع النوع فريد»
بالعودة إلى «الراب»، أو ذلك الفن الخارج عن «النوع» الذي بات يحتل المساحة التي أرادها له جمهوره، حتى صارت أكبر الشركات في مختلف الدول تتعاقد مع مغنيه للظهور في إعلانات منتجاتها، بل ويُستخدم اليوم في كثير من تترات المسلسلات والأغنيات الدعائية لكثير من الأفلام.. بالعودة إليه، وإذا أنصتنا جيدًا لما يقوله هؤلاء الذين ظن شركائي في عشاء صديقتي أنهم يقولون كلامًا فارغًا بلا معنى، سنجد أن أصحاب هذا الفن أنفسهم يدركون أن كلامهم لن يكون مفهومًا لدى الجميع بالضرورة. «ويجز» مثلًا، أحد أشهر الرابرز العرب -إن لم يكن أشهرهم-، يقول في واحدة من أغنياته: «لو مش فاهم مابشرحش».
وبالعودة إلى المهرجان السينمائي الذي عُرِض فيه «مشط بدون أسنان»، وأمطَرَ جمهوره صُنَّاع الأفلام بأسئلة ساعية إلى «فهم الفن»، من نوع: «لماذا اخترت تلك النهاية؟» و«ما معنى ذلك المشهد؟» و«ما علاقة الرقص بالغضب؟»، فقد كان الفيلم الوحيد الذي لم يحضر صُنَّاعه العرض بعنوان «سيمو». يتابع الفيلم حياة مراهق مصري مُغترب لا يربطه ببلده سوى استماعه باستمرار إلى أغاني الراب، ويخصص «سيمو» مساحةً مُعتبَرة -بالنظر إلى كونه فيلمًا قصيرًا- لهذه الأغاني كأنها بطل من أبطاله. يروي الفيلم حكاية مثيرة جدًا للاهتمام وللأفكار ويتناول موضوعات مهمة -مثل الإسلاموفوبيا وتربية المراهقين- بخِفة لطيفة لا تنزع عن الموضوعات جديتها.
حين انتهى العرض، بل قبل أن ينتهي تمامًا، بدأتْ موجة تصفيق كانت الأطول والأكثر حرارةً طوال أيام المهرجان، وهو ما أكده لاحقًا فوز الفيلم بجائزة الجمهور. أحكي هذه الحكاية لأن ذلك الفيلم يُختتَم بنظرة مُتحدية يصوَّبها بطله المراهق للجمهور مباشرةً، بينما تصاحبها أشهر أغنيات مَن؟
نعم، مروان بابلو.
ماذا نفعل حين نعجز عن فهم الأعمال الفنية؟
بالانفتاح والتصالح نفسه، يمكننا أن ننظر إلى الأعمال الفنية على طريقة «غريب ولكن أحببته». ثمة الكثير الذي يمكننا فعله عندما يستعصي علينا فهم الفن.
١. بدلًا من المعنى، فلنبحث عن السياق
حين نقف أمام لوحة فنية تجريدية يصعب تفكيكها، أو حين نحضر عرضًا فنيًّا يخلو من كل ما اعتدنا فهمه ببساطة، بإمكاننا أن نجد بعض التلميحات في عناصر مثل اسم الفنان، أو محل مولده، أو محل عمله، أو سنة إنتاجه للعمل، أو عنوان العمل نفسه. كلها عوامل قد تساعد في شرح الظرف التاريخي والاجتماعي والنفسي الذي أُنتِج فيه العمل، وبالتالي محاولة «تفكيك» العمل نفسه.
٢. ربما لم نفهم، لكن لا يزال بإمكاننا أن نشعر
بعد سنوات من مشاهدة نوع معين من الأفلام دون غيره، من الطبيعي أن تتوقع أن يتكون أي عمل سينمائي من مجموعة شخصيات وحبكة درامية ذات بداية وعقدة ونهاية. لكن، في المرة المقبلة، إذا صادفت فيلمًا يخلو من كل تلك العناصر، أرِح عقلك قليلًا واسمح لنفسك بترك أفكارك جانبًا والتركيز فقط على مشاعرك. ربما تظن أنه ليس بإمكانك «فهم» شيء، لكن ألا تجعلك الصور والأصوات «تحس» شيئًا؟
٣. لنصنع فنًا على طريقتنا
ليس معنى كل ما سبق أن أي عمل فني هو جيد بالضرورة، أو ذو معنى، أو فيه من المشاعر ما يمكن استخلاصه. ربما تصادف أعمالًا يُقِر مبدعوها أنفسهم بأن لا معنى لها، وأنها قد جاءت وليدة الصدفة أو الحدس اللحظي. حينها بإمكانك خلق علاقتك الخاصة معها، على طريقة «أشعار تشبه أحلامي في الليل، وأفكاري تحت الحمى». وقد تُصادِف أعمالًا فيها ما فيها من معانٍ ومشاعر لكنها ببساطة لا تعرف طريقًا إليك. حينها عليك إما أن تتحول أنت نفسك إلى مبدع لتعبِّر بطريقتك عما لم تجده في إبداعات الآخرين، أو أن تبقى متلقيًّا وتنتقل ببساطة إلى العمل التالي.
٤. لنتدرَّب على الأسئلة
الآن وقد أشرت إلى اختلافي مع جزء جوهري في أدب إدوار الخراط، يمكنني أن أستخدم كلماته لمرة أخيرة، دون خوفٍ من أن أبدو كأني مهووسة به. وفي الوقت نفسه، قد يقنعك هذا -للمرة الأخيرة أيضًا- بإمكانية الاختلاف مع جوانب معينة لأعمال مبدعٍ ما، أو عدم فهم الفن الذي يقدمه أحيانًا، دون أن يستوجب ذلك إنكار إبداعه بالكامل.
«تعالَ معي نسأل معًا: كيف نسأل؟ وماذا؟ وعمَّ نسأل؟ تعالَ معي في رحلة البحث هذه التي مهما انتهت إلى مراحل فهي لا تنتهي إلى خواتيم.. إلى نهايات.. بل تتفتَّح دائمًا كل مرحلة فيها عن طرق جديدة، وعن آفاق غير مسبورة باستمرار.. بلا نهاية»..
Recent Posts
سينما زاوية، أكثر رحابة: حكاية طابور طويل أمام دار عرض في القاهرة
نُشر هذا المقال أولًا على موقع «بي أوبن»، النسخة التجريبية لـ«منشور»، عقب الدورة الثامنة من…
الفيلم الوثائقي: ما هو؟ وما الفرق بينه وبين الفيلم التسجيلي؟
ربما قد سمعت المصطلح من قبل خلال متابعتك مهرجانًا سينمائيًا ما، أو شاهدت قناة تليفزيونية…
في اجتماع العزلة والترحال: 6 أفلام عن الوحدة والسفر
يقول أحدهم: «إننا نسافر؛ لا لنهرب من الحياة، بل لئلا تهرب الحياة منا»، ويُقال الكثير…
أفلام المرأة: 5 من أجمل بطولات السينما النسائية
في عالم موازٍ، لا أتبنى مصطلح «أفلام المرأة»، لكن ثمة نظرة تُقسِّم العالم إلى قسمين:…
ثورة ٢٥ يناير: تركة سنوات من الخذلان
في الذكرى الخامسة لـ ثورة ٢٥ يناير، نُشر هذا المقال على النسخة التجريبية لموقع منشور…
اذكرينا يا شوارع: لماذا علينا أن نحكي عن ثورة ٢٥ يناير؟
نُشر هذا المقال عام ٢٠١٦ على موقع «بي أوبن»، النسخة التجريبية لـ«منشور» كافتتاحية تلاها مقال…

